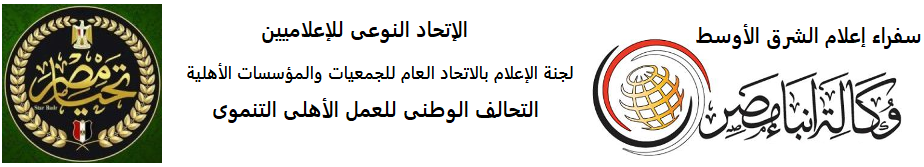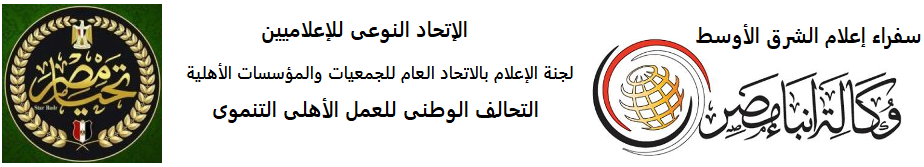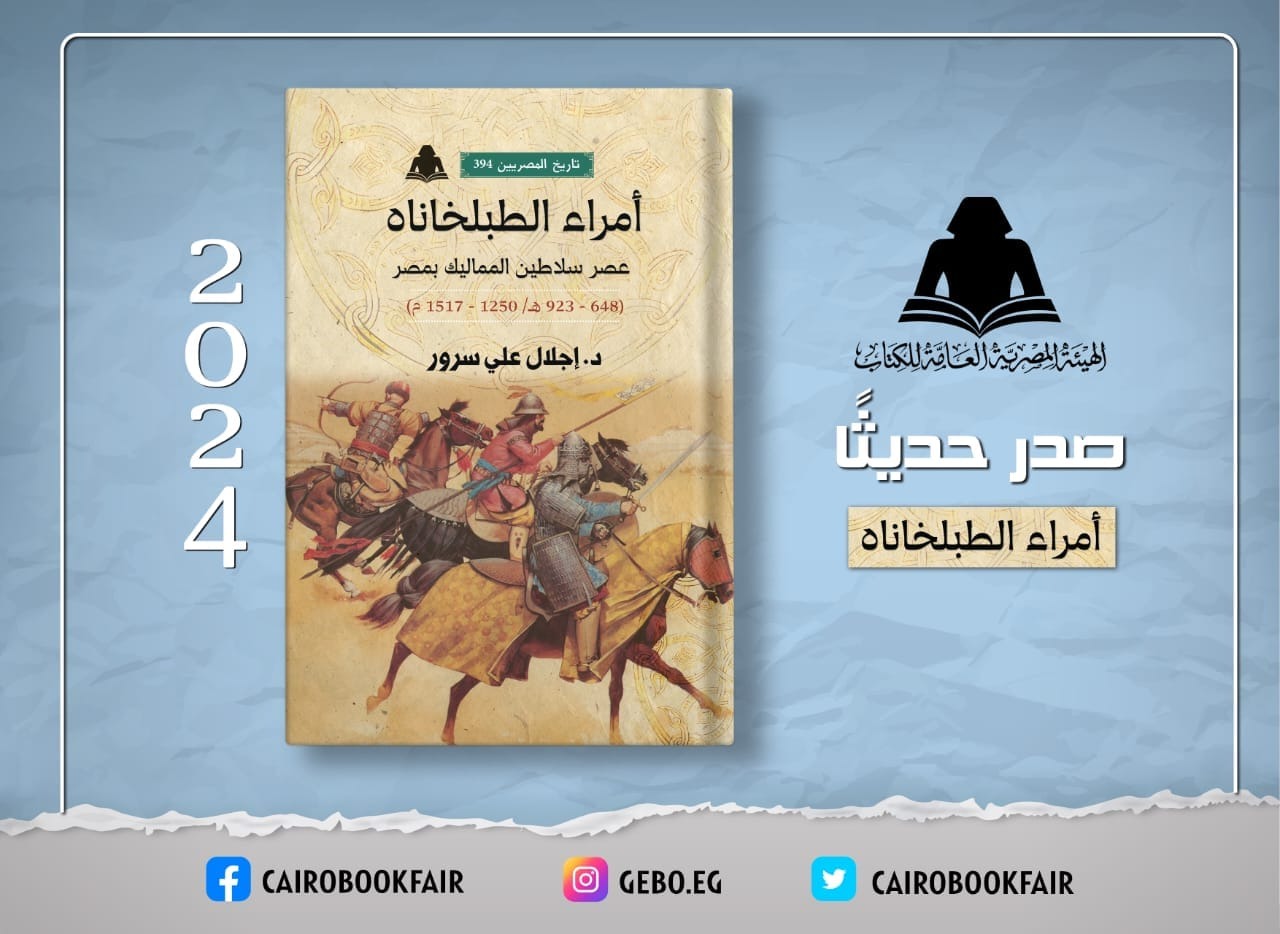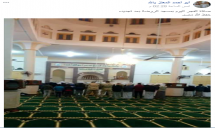- استطلاع رأى
- القائمة البريدية
- معجبى الفيس بوك
- معجبى تويتر
التنمية والسقوط في شباك العنكبوت (2)

*باحث في شئون التنمية والمجتمع المدني
بقلم: محمد ممدوح عبدالله
مع بداية ثمانينيات القرن الماضي، تشكلت ملامح ظاهرة العولمة، كفلسفة وأدوات تطبيق؛ وهي الظاهرة التي استهدفت العمل علي رفع جميع الحواجز؛ الاقتصادية، الثقافية، والسياسية، بين دول وشعوب العالم، بدعوى تحسين حياة الشعوب بالتقارب والتعاون المشترك، حيث ساهم في نموها التطور السريع في تكنولوجيا الاتصالات وأساليب تداول المعلومات، بالإضافةإلى الثورة التي استهدفت تكنولوجيا الإعلام والتسويق، وهو ما يسر تسويق الأفكار والمعتقدات، بالإضافة إلى ما تم ترويجه من مفاهيم تحت مظلة العولمة، والتي ساهمت في زيادة مساحة الحريات، وتسهيل انتقال الأفراد، وحرية انتقال رؤوس الأموال من مكان لآخر.
ففي ظل العولمة أصبح العالم وكأنه قرية صغيرة، يعيش فيها جميع شعوب العالم، يتأثرون ويؤثرون بعضهم ببعض؛ فما يحدث في الصين على سبيل المثال، يؤثر في العالم ككل، ويتسبب في توجيه صانع القرار على المستوى الدولي والقومي والمحلي.
ونتيجة لهذه الحالة، ارتبط ما هو محلي، بما هو عالمي ، وتم عولمة كل الأنشطة الإنسانية ، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، والسياسية، وهو ما أتاح للدول الأقطاب، في النظام العالمي - وهي الدول ذات الثقل العسكري، والاقتصادي، والعلمي، والتكنولوجي - أن تمتلك من النفوذ والقدرة، للتأثير علي إدارة أدوات العولمة، والتحكم فيها، وتسخيرها في سعيها للهيمنة، الاقتصادية والثقافية والسياسية، والحفاظ على مركزها المتقدم في التأثير الدولي، خاصة وأن العولمة قد تسببت في تأجيج الصراع والتنافس الدولي بين الأقطاب، في المجال الاقتصادي، والذى امتد إلى المجال الثقافي والحضاري للشعوب ، بدلاً من التعاون من أجل حياة أكثر رفاهية للإنسانية، كما ادعى دعاة العولمة٠
وتعتبر العولمة الثقافية، أحد صور هذه الهيمنة، حيث استهدفت إذابة كل الثقافات وأنماط المعيشة، والمعتقدات، والأفكار، لدى الشعوب، وصهرها في بوتقة واحدة، لإنتاج ثقافة عالمية، متفق عليها، ولكن ،فعليا، عكست تلك الثقافة العالمية بمكوناتها المختلفة ثقافة الأقطاب التي تدير أجهزة وأدوات العولمة، الساعية لإخضاع العالم بمقدراته للهيمنة.
ولقد أخذت العولمة الثقافية منحى خطير في طريق تهديد مسيرة شعوب العالم، بفرض ثقافة أحادية الرؤية بأبعادها الأخلاقية والقيمية، وتسويقها لشعوب العالم على أنها النموذج الأوحد للتقدم والرقي، تحت مسمى الثقافة العالمية، ودعم ذلك الاتجاه منظومة إعلامية عالمية تصدر رسالة مفادها "أن التنوع والاختلاف الثقافي والحضاري بين شعوب العالم كان مصدرا للصراع عبر التاريخ، ولكي نتخلص من ذلك الصراع ويسود السلام بين البشر، يجب أن نعمل على إنتاج دين وثقافة عالمية واحدة، بجوار حكومة عالمية، وهو ما يتم تشكيله منذ فترة".
وفي ظل تلك الحالة، تم توجيه النقد والهجوم علي كل ما هو موروث، من أفكار، وقيم، وأخلاقيات، ورؤى اجتماعية، وعادات، وامتد ذلك إلى الأديان، بما أنها جزء أصيلا من ثقافة المجتمع؛ فقد تم تسخير كل أدوات العولمة لكي تعمل معًا، ومنها آلة الإعلام العالمية، والمراكز البحثية، لتربية وتأهيل دعاة، لإثبات عدم جدوى ذلك الموروث الثقافي، وتصدير دعوة لشعوب العالم، بأن ذلك الموروث أحد معوقات التنمية والتحضر.
ويمكن إرجاع اهتمام الساعين إلي تحقيق الهيمنة والسيطرة على مقدرات العالم، بالموروث الثقافي للشعوب، إلى أنه يعتبر أحد الموانع ضد فكر الهيمنة؛ فكل موروث ثقافي يتضمن بشكل تلقائي بداخله عوامل الحفاظ عليه، وعلى من يحملونه؛ فالمصير المشترك، ووحدة الثقافة، كلها من العوامل التي تستدعي الدفاع، وصد أي محاولات للسيطرة والهيمنة على الشعوب.
لذا كان العمل على إزاحة وتهميش ثقافة الشعوب، بشكلها الحالي، كعامل مؤثر في الحياة الاجتماعية، والاقتصادية لشعوب العالم، ومحاولة الوصول به إلي حالة رخوة، وأن تفقد هذه الشعوب قدرتها كمرجعية اجتماعية، وتفقد تأثيرها بحياة الشعوب، وإحلال بدلا منها الثقافة العالمية، تحت مظلة العولمة الثقافية، وإتمام الهيمنة بدء من السيطرة علي العقل الجمعي للشعوب والعمل على تشكيله، وانتهاء بالسيطرة على الموارد الاقتصادية، وتوظيفها لخدمة الأقطاب؛ وبهذا سقط العالم في شباك العولمة، كما تسقط الفرائس دون إدراك في شباك العنكبوت، الذي يقوم بتخدير الفريسة لاستكمال السيطرة عليها.
هذه الأوضاع كان من نتائجها، التهديد، وبشكل مباشر لسيادة، الدول، الاقتصادية، والثقافية، والسياسية، خاصة الدول العربية والإسلامية، ما تسبب في اشتعال الصراع الطائفي، كما حدث في الوطن العربي، ودخوله في حالة الفوضى، التي يعاني منها العالم الآن، وبهذا أصبح العالم في ظل العولمة بين قوتين، متضادتين؛ قوة تسعى للتجميع والتقارب تحت مظلة مفاهيم، تدعي في ظاهرها السلام العالمي ورقي البشرية؛ وقوة أخرى تسعى إلي الصراع والتناحر والتنافس في نفس الوقت، من أجل محاولة الحفاظ على الخصوصية الثقافية والمكتسبات الاقتصادية لهذه القوة.
فبعد أن كان الموروث الثقافي للأمة الواحدة، يشتمل على تنوع، ويعتبر مصدر ثراء حضاري لها على مر العصور، أصبح في ظل العولمة الثقافية مصدر يهدد البقاء والاستمرار؛ والطامة الكبرى، ما قدمته العولمة من أدوات، ساعدت على مرور التنظيمات الظلامية، وبث الأفكار الشيطانية الضالة داخل المجتمع الإنساني، وتسويقها عبر نافذة العولمة، مستغلة التقارب، ورفع الحواجز. ولوجود التربة الصالحة لتقبل كل هذا، بعد أن تم الهجوم على كل موروث ومنه الدين، و إضعافه كمرجعية أخلاقية، كان ذلك الموروث يحتوي على مضادات طبيعية لمواجهة تلك الأفكار.
ومن أكثر الفئات التي تأثرت بتلك الأوضاع الشباب والأجيال الحالية، فنتيجة لهذه الحالة، وارتباط المحلي بالعالمي، والدعوة لمفاهيم للعولمة الثقافية، أصبح السواد الأعظم من الشباب ولاءه وانتماءه للثقافة العالمية، وليس للثقافة المحلية، في ظل العولمة الثقافية، فأصبحت هي التي تشكل وجدانه وأفكاره، وبالتالي أحلامه واهتماماته.
إن الناظر إلي واقع المجتمع المصري اليوم، والتحول الحادث في الشخصية المصرية، وما شابها من تشوه يخالف الموروث الثقافي، يجد أننا نواجه أزمة ثقافية أخلاقية فكرية قيمية، تمتد الي أزمة هوية لدى الأجيال الحالية والقادمة، ولا نغالي إن و صفناها بشيزوفرينيا اجتماعية ثقافية، وهي حالة توصف بتضارب السلوك المجتمعي للفرد بين نمطين اجتماعين مختلفين، لكل منهم مرجعية مختلفة من حيث القيم ونمط التفكير والسلوك، ما أوجد الكثير من الأزمات الاجتماعية تمتد إلي الاقتصاد والسياسة، فكل ما نواجه من أزمات مجتمعية، ماهي إلا نتيجة لفقدان الموروث الثقافي، أو تشوهه وتحييد دوره في بناء شخصية الفرد.
ولقد ساعد علي ذلك انسحاب الدولة خلال العقود الماضية، من صياغة مشروع حضاري ثقافي حقيقي، لبناء الإنسان، يستمد من الموروث الثقافي أدواته، ورغم المحاولات التي تتم من الدولة الآن لملىء هذا الفراغ، فإنه مازال دور ضعيف، ولا يرقي لحجم المشكلة؛ فلم تنتبه الدولة المصرية عبر العقود الماضية، لتلك المخاطر، والعمل على مواجهتها، بل كان من أولوياتها إحداث التنمية الاقتصادية، والتركيز على الصراع والتنافس الاقتصادي العالمي، وكيفية مواجهته، دون الإدراك بأن دعم الهوية الوطنية بأبعادها الثقافية، والاجتماعية، والدينية، أحد اهم العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاجتماعي، بل الاقتصادي والسياسي أيضا، فهى قضية ترتبط بالتنمية، كما أنها قضية أمن قومي في ظل هذا الصراع.
ولكن ما المخرج لنا كأفراد وشعوب، للفرار من شباك فخ هذا العنكبوت؛ ألا وهي العولمة الثقافية؟
بداية، الأطراف الدولية حاليًا في ظل العولمة، إما فاعل أو مفعول به، فلكي نكون فاعلين، يجب أولاً الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع، والخروج من إطار الهيمنة الثقافية للعولمة، بانتهاج أنماط معيشية تستند إلى المخزون الحضاري لمصر، والعمل على تصديره، ومن هنا تنبع الصعوبة، وإن كان ذلك ليس مستحيلاً، باعتبار أن تلك القضية قضية أمن قومي ووجود.
نحن في حاجة إلى مشروع، تتشارك فيه مؤسسات الدولة الثقافية، والإعلامية، والشبابية، والرياضية، والاجتماعية، والدينية، بجانب منظمات المجتمع المدني الوطنية ...الخ؛ تعمل معا، وليست منفردة لصياغة مشروع نهضة ثقافية، لاستعادة الهوية المصرية؛ مشروع يعمل على علاج ما لحق بالشخصية المصرية من تشوه، واستكمالا لذلك يجب أن يسمى رجال الدين فوق الطائفية، وأن يعملون معاً بشكل حقيقي وملموس، وليس شكليا، وذلك بتوحيد مجهوداتهم، والعمل على إشاعة السلام، والمحبة، والاحترام للآخر، وأن يغلب علي تفكيرهم صالح المجتمع ككل.
إن مواجهة طوفان العولمة الثقافية، لن يأتي إلا بامتلاكنا نظم حماية ثقافية، تعمل علي ترسيخ الهوية المصرية الأصيلة، في مقابل العولمة الثقافية، فنحن في حاجة إلى مشروع حضاري يمشي عكس تيار العولمة الثقافية، ويواجه سلبيات العولمة، ويرتكز على الهوية المصرية والموروث الثقافي، بما يحمله من مخزون حضاري يستند إلى القيم الإسلامية والمسيحية، وهناك عدد من المقترحات لتحقيق ذلك؛ أهمها:
1. استعادة التربية لوزارة التعليم، ودمج قضايا الهوية والموروث في المناهج التعليمية.
2. تطوير كليات التربية، واستعادة مقومات المعلم متعدد المهام المجتمعية٠
3. إعادة صياغة دور المؤسسات الثقافية والإعلامية، واستعادة دورهما التنموي.
4. صبغ حياتنا اليومية بأبعاد الهوية الوطنية والثقافية، مثل تعظيم دور اللغة العربية والفلكلور الشعبي، وإحياء مدارس الأدب والفنون المصرية.
5. تأسيس مراكز لتنمية الفنون المختلفة داخل المجتمع، وربطها بالموروث الثقافي ورعاية المبدعين.
6. استعادة مراكز القوة الناعمة لمصر، والتي كانت في الماضي منارة إشعاع للتأثير وصياغة الوجدان والفكر لشعوب المنطقة.
7. استعادة المؤسسات الدينية لدورها في نشر وترسيخ منظومة القيم والأخلاق المستمدة من الأديان السماوية.
8. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، بما لديها من أدوات في تعزيز قضية الهوية الوطنية والاستقرار.
كل هذا مع أهمية التأكيد على انعكاس خطط الدولة، في المجالات المختلفة، لا سيما الموروثات الثقافية والاجتماعية، واعتبارها قضية أمن قومي ووجود، حتى تؤتي التنمية ثمارها الحقيقية، في تعزيز الاستقرار والحفاظ على الأرض، كي لا نفاجأ بعد فترة، بشعب آخر، يسكن أرض مصر، ينتمي وجدانيا إلى عالم افتراضي، أو لثقافة أخرى؛ شعب لا تجمع أفراده أي قواعد مشتركة، ويسهل تطويعه لتحقيق مخططات سقوطه في شباك العنكبوت.
إقرأ أيضا
-
 د/جيهان عبد الواحد رئيسا للقطاع الاجتماعي باتحاد المرأة المتخصصة
د/جيهان عبد الواحد رئيسا للقطاع الاجتماعي باتحاد المرأة المتخصصة
-
 11/11 ثورة الغلابة .. عودة من جديد لميدان التحرير
11/11 ثورة الغلابة .. عودة من جديد لميدان التحرير
-
 أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/11/2016.. وعيار 21 يستقر عند 580 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/11/2016.. وعيار 21 يستقر عند 580 جنيهًا
-
 الزمالك يهزم 6 أكتوبر 3 / 0 فى نهائيات دورى الطائرة
الزمالك يهزم 6 أكتوبر 3 / 0 فى نهائيات دورى الطائرة
-
 رجل الاعمال اليمني المعروف / علي عبد الله صالح المريسي يحتفل بزفاف نجليه "نسيم"و"حسام"
رجل الاعمال اليمني المعروف / علي عبد الله صالح المريسي يحتفل بزفاف نجليه "نسيم"و"حسام"
تعليقات